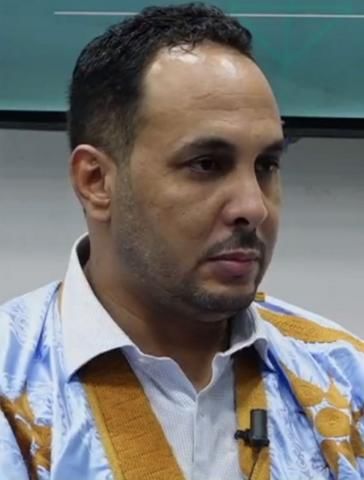تطرح إشكالية الولاء داخل الإدارة العمومية سؤالا جوهريا في علم الاجتماع السياسي: لمن يُفترض أن ينتمي الموظف في دولة حديثة؟
هل ينتمي لمؤسسات الدولة التي تقوم على القانون والحياد والجدارة، أم ينتمي لشبكات النفوذ التقليدية التي ما تزال تؤثر في مسار التعيين والترقية؟
يدخل الموظف الشاب الوظيفة العمومية عادة بدافع خدمة الوطن، مستندا إلى نجاحه في مسابقة رسمية في الغالب – أو كهذا نص القانون (انظر المادة 51 من القانون 093 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين)- غير أنّ هذا التصور الأولي سرعان ما يصطدم بواقع إداري واجتماعي أكثر تعقيدا؛ فالكفاءة وحدها، لا تكون غالبا معيارا للترقية أو التقدير ، وبهذا يجد الموظف نفسه -في كثير من الأحيان- محاصرا بين مسارين:
– مسار الدولة الذي من المفترض أن يعتمد على الكفاءة
– ومسار العلاقات الشخصية والقبلية الذي يعتمد على الواسطة والنفوذ
هذا التداخل المربكُ، هو ما يصفه عدد من الباحثين الغربيين بمفهوم النيو-إقطاعية السياسية ( Néo-féodalisme politique )، قياسا على “الإقطاع التقليدي القديم” المعروف في العصور الوسطى..
حيث يشير عالم الاجتماع، والسياسي الفرنسي جان-فرانسوا بايار في كتابه (الدولة في إفريقيا: سياسية البطن L’État en Afrique : La Politique du Ventre ) إلى أن <<بعض الدول تُدار بطريقة تجعل المؤسسات الحديثة واجهة رسمية تغطي واقعا يُعاد فيه توزيع المنافع على أساس الولاءات الشخصية وشبكات النفوذ>>…
وبهذا يصبح الموظف -الذي يلتحق بالوظيفة بدافع خدمة الوطن- عُرضة لهذا التداخل البنيوي؛ فحين يُلاحظ أن الترقية لا تعتمد فقط على الأداء، بل على الوساطة، يبدأ في البحث عن “جهة الولاء الخاصة به”.
ومن هنا تبدأ إشكالية الولاء في التشكُّل: الموظف الذي كان ولاؤه للدولة يصبح تدريجيا مدفوعا لمنطق مختلف، حيث يرتبط تقدمه المهني بمن له قدرة على فتح الأبواب، لا بمن يمثل المؤسسات.
وهكذا، يتحول الولاء من ولاء مؤسسي إلى ولاء شخصي، وتتحول الترقية من حق مهني إلى “منحة” مرتبطة بالجهات المؤثرة.
وبنفس المنطق يتحول الموظف من مقدمة خدمة تتميز بالعمومية والتجريد، إلى خادم لأجندات خصوصية ومحددة (لا تتجاوز جهة الولاء).
الشيء الذي ينعكس سلبا على جودة أداء الإدارة العمومية، بعدة طرق لعل أهمها:
1- إضعاف مبدأ حياد الإدارة العمومية، إذ تُصبح الوظائف أداة تُستثمر لخدمة مصالح شخصية أو قبلية
2- تراجع مكانة الكفاءة كشرط أساسي للتعيين والترقية، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات العمومية
3- انقسام ولاء الموظف بين مقتضيات الوظيفة من جهة، وضغوط البنية الاجتماعية من جهة أخرى، بما يخلق حالة من عدم الاستقرار الأخلاقي والمهني
4- تعميق فجوة الثقة بين المواطن (طالب الخدمة) والإدارة (الدولة) ، حيث يتولد شعور لدى الأول بأن من سيخدمه لن يكون بالكفاءة المطلوبة، ما يجعله غير مطمئن للخدمة المقدمة.
والمؤكد أنّ بناء إدارة عمومية قوية يتطلّب بالدرجة الأولى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يدفع الموظف إلى الاستقواء بشبكات النفوذ القبلية و السياسية، ولن يتم ذلك إلا :
– بتكريس الولاء المهني للدولة
– وضمان أن تبقى الترقيات والامتيازات مرتبطة بالأداء والكفاءة
عندها لن يتوانى الموظف لحظة في أن يكون ابنا للدولة بحق، وأن يوجّه جهوده لخدمة المصلحة العامة دون مَنٍّ من شيخ قبيلة – ينتظر ثمار وساطته- أو أذى رئيس حلف كان يظن أن “كرعته ستكون أوفرَ”.